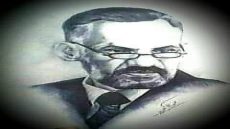بقلم: أميمة بونخلة باحثة في الفكر الاسلامي
في الوقت الذي ما زال فيه العالم العربي يتلمس طريقه داخل دهاليز إصلاحات تعليمية متعثرة، تُنفق فيها الموارد وتُصاغ فيها البرامج، ثم تعود إلى نقطة البدء في صمت يشبه الفشل الممنهج، تنبعث من الشرق تجارب آسيوية تُربك التصنيفات، وتكسر احتكار النموذج الغربي في تمثيل النجاح التعليمي والحضاري. هذه التجارب، بما هي عليه من خصوصية بنيوية وجذرية، لا تصلح فقط كمصدر للإلهام، بل كمختبر نقدي يعيد تشكيل الوعي التربوي العربي خارج الأطر المعلّبة التي أُريد له أن يبقى سجينها. فما قامت به كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، بل حتى رواندا التي تفكر كآسيا أكثر من جغرافيتها الإفريقية، هو أكثر من تحديث للمنظومة التربوية: هو إعادة تعريف شاملة لفلسفة التعليم، تُعيد الإنسان إلى مركز العملية دون أن تحوله إلى ترس في آلة إنتاجية معولمة.
التجربة الآسيوية لم تنطلق من فرضيات استشراقية تنظر إلى الذات بوصفها قاصرة عن الرقي، بل من يقين حضاري يرى في الخصوصية قوة دفع لا عائقًا. وهو ما يجعلها تتمايز جوهريًّا عن النموذج الأوروبي الذي نُقل إلينا في الحقبة الاستعمارية، والذي ما زالت ظلاله تُخيّم على المدرسة العربية في شكل مناهج مفصولة عن السياق، وطرائق تدريس تُرَبّي على التلقي لا الإبداع، وتُفرز مواطنين صغارًا لا ذواتًا فاعلة. في المقابل، تبدأ المدرسة الآسيوية من الطفل، من بيئته، من لغته، من عاداته الصغيرة في الاحترام الجماعي، في النظافة، في تقديس الزمن، في العمل الصامت. فقبل أن يُعلموه الحروف، يعلمونه التواضع، وقبل أن يلقنوه الحساب، يزرعون فيه المعنى.
المدرسة هناك ليست فقط فضاءً للتعلم، بل هي مؤسسة رمزية لإنتاج الإنسان كما يجب أن يكون، متماهيًا مع جماعته دون أن يذوب فيها، فخورًا بلغته دون أن ينغلق على الآخر، منخرطًا في العصر دون أن يضيع في ثقافته. وهذا ما يجعل التجربة الآسيوية تسير في خط مغاير تمامًا لما تُبشّر به الحداثة الغربية في نسختها النيوليبرالية، التي حوّلت المدرسة إلى حقل تجارب اقتصادي، والتلميذ إلى عميل مستقبلي لشركات سوق العمل. فحين تنتصر الرؤية الآسيوية، فهي لا تنتصر لأرقام التنافسية أو مؤشرات الجودة فقط، بل تنتصر لفكرة أن التقدم لا يكون على حساب الإنسان، بل من خلاله
.إن من يقرأ التجربة اليابانية، لا بد أن يندهش من قدرتها على الجمع بين التكنولوجيا والانضباط القيمي، بين أقصى درجات التحديث وأقصى درجات الوفاء للذات. فبينما ينتج الغرب أدوات الذكاء الاصطناعي لتُدار بها المنظومات، تُنتج اليابان أدوات الذكاء الجماعي، لتُدار بها الحياة. هناك، لا يُختزل المعلم في دوره الوظيفي، بل يُنظر إليه باعتباره صانع المعنى، ومهندس الهوية، وحامل الذاكرة الجماعية. وما لم يُستوعب هذا البعد الرمزي، ستظل مدارسنا العربية تراكم الأجهزة وتفشل في بناء الإنسان.
وإذا كانت سنغافورة قد قررت من اللحظة الأولى أن لا تجعل الفقر ذريعة للتخلف، فإنها في المقابل رفضت أن تكون مجرد نسخة محسّنة من أنظمة الغرب. فقد بنت نموذجًا تعليميا يضع العدالة في صلب رؤيته، حيث لا تَفصل جودة التعليم بين مركز وضاحية، ولا بين من يملك ومن لا يملك. فكل طفل مشروع دولة، لا مشروع أسرة. وهو منظور لم تستطع كثير من الدول العربية بلوغه، حيث ما تزال الأنظمة التعليمية تُعاد إنتاجها لتكرّس الفوارق بدل أن تردمها، وتُعد التلاميذ للنجاة الفردية بدل المساهمة الجماعية.
المؤسف في السياق العربي أن كل محاولة للإصلاح التربوي تكاد تبدأ من حيث انتهى الآخر، لا من حيث ينبغي أن نبدأ نحن. فاستيراد البرامج والنماذج الجاهزة هو في ذاته شكل من أشكال العجز المعرفي، والكسل الثقافي، الذي يجعلنا نُعيد إنتاج المركزية الغربية من موقع التابع لا الشريك. والحال أن ما تدعونا إليه التجربة الآسيوية ليس الاستنساخ، بل اليقظة؛ يقظة تُذكّرنا بأن لكل أمة حقها في أن تُصوغ طريقها بنفسها، انطلاقًا من مقوماتها الروحية، ورصيدها الرمزي، ومشروعها المجتمعي.
إن الدرس الأكبر الذي تقدمه آسيا للعالم، ليس كيف تبني مدرسة جيدة، بل كيف تبني إنسانًا لا يحتاج لأن يتخلى عن هويته ليصبح “حديثًا”، ولا لأن يتنكر لتاريخه كي يصبح “فعّالًا”. إنها تقترح علينا أن الطريق إلى المستقبل لا يمرّ بالضرورة عبر بوابة باريس أو لندن أو نيويورك، بل قد يبدأ من طوكيو أو سيول أو حتى كيغالي، إذا امتلكنا شجاعة السؤال: من نحن؟ وماذا نريد من التعليم؟ وهل يكفي أن نُجيد القراءة والكتابة لندّعي النهوض؟
في الختام – وليس نهاية – لا بد من القول إننا في حاجة إلى انقلاب مفهومي هادئ يعيد تعريف علاقتنا بالتعليم، لا بوصفه أداة للتوظيف أو الصعود الاجتماعي فقط، بل بوصفه سؤالًا وجوديًّا عن الذات، عن مصيرها، عن دورها في عالم يعيد توزيع القوة والمعرفة. وما التجربة الآسيوية إلا مرآة نُبصر فيها إمكاناتنا، بعيدًا عن التبعية، عن الغرور الحضاري، عن التصورات الجاهزة التي تحصر “المركز” في الغرب، وتجعل من بقيّة العالم مجرد هامش يلهث خلفه. آن الأوان لأن نُصغي لما تقوله آسيا، لا بوصفه صوتًا غريبًا، بل بوصفه جزءًا حيًّا من الذاكرة الإنسانية التي تسعى، مثلنا، إلى العدل والمعنى والكرامة.